أصداء مايو 68 بلا نهاية: مداولات مع جان لوك نانسي
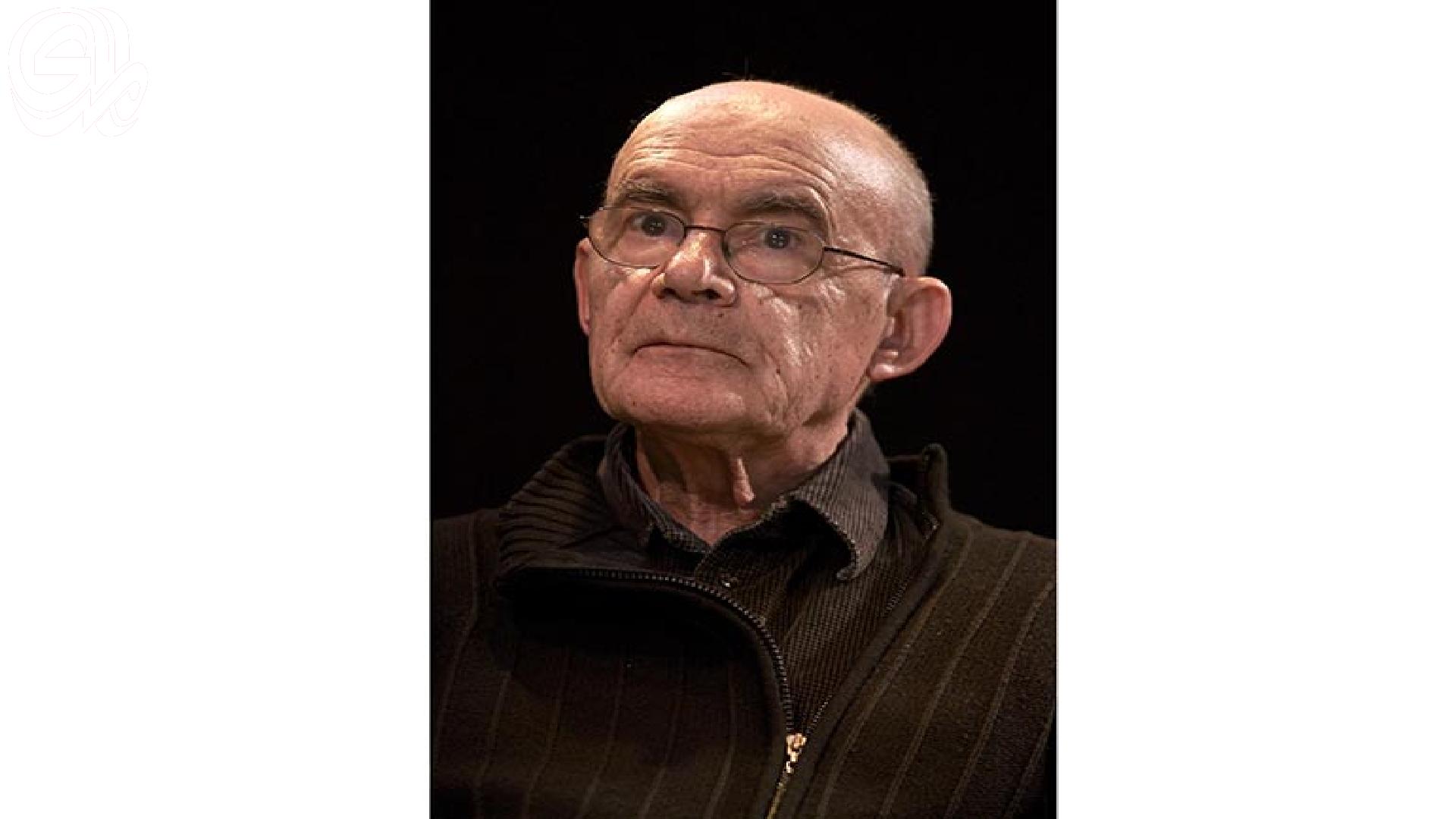
5019 (منارات)
منارات ,
ترجمة: أحمد حسان
انطلاقًا من خبرته المعيشة، يقدم الفيلسوف جان ـ لوك نانسي في هذا الحوار شهادتَه عن تأملاتِه في ظاهرة 68 المذهلة، في امتدادٍ لكتابه المنشور لدى جاليلي عام 2008( حقيقة الديموقراطية ) . كان 68 ميتافيزيقيًا أو روحيًا أكثر من كونه اجتماعيًا، أو سياسيًا، أو ثقافيًا، أو ما شئت. بالتأكيد، كان كل ذلك أيضًاً: لكن عمق المسألة، التوهج الخاص بتلك اللحظة، كان هذا التحوّل، تعليقَ تَوجُّهٍ للمعنى لم يكن يُعرِّف ما هو أقلّ من الحضارة الغربية.
ك ديلي عادةً ما يُقدَّم 68 باعتباره أحدَ أهم الحركاتِ الاجتماعية في التاريخ الفرنسي، التي كانت ستصبح في الآن ذاته طلابيةً وعمالية، مصحوبةً بسُعَار المناقشات والسجالات في الجامعات، والمصانع، والمسارح، والشارع، كرد فعلٍ ضد السلطة القائمة، والمجتمع التقليدي، والاقتصاد الرأسمالي، وبالرغبة في تحوُّلٍ جذري للحياة وللعالم... هل ستلخِّصُ الأشياء على هذا النحو؟ هل شاركتَ في أحداث 68؟
جان ـ لوك نانسي : لا، لن ألخِّص الأشياءَ على هذا النحو، لأنني بكل بساطة غير قادر على محاولة إجراء مثل هذا التلخيص: كان الأمر يتطلَّبُ كفاءةَ مؤرِّخ أنا أبعدُ ما يكون عن امتلاكها. وحقيقة أن المرء قد عاش 68 لا تمنحُ سوى القليل من الميزات على أي شخصٍ يكون قد راقبَها بدل أن يعيشَها وأعادَ تأسيسَ التاريخ فيما بعد. مثل تلك الظاهرة لا تتم السيطرةُ عليها في لحظتها، أو على الأقل تُسلِم نفسَها لسيطرةٍ سيئة. ومن المؤكد فضلًا عن ذلك أنني عشتها بطرقٍ مختلفة تبعًا للّحظات وتبعًا للأماكن بدرجةٍ ما (كنت في المقام الأول في ستراسبورج وقليلًا جدًا في باريس). جرت لحظاتٌ شعرتُ فيها باجتياح «الحركة الاجتماعية» كما تقولين (إصلاحاتٌ أو تحولات ضرورية)، ولحظاتٌ أخرى ساد فيها الجانبُ السياسي (يسارٌ متطرف ضد يسارٍ شيوعي و/أو اشتراكي)، وأخرى ساد فيها الاحتفالُ الأناركي (نشوة تعليق الأمور، أي شلّ كل الوظائف. . .). أما ما ترك فيَّ أعمق الأثر فكان هذا: مع بعض الأصدقاء، في ستراسبورج (حيث سبَقَت 68 بعامين بعضُ الأفعال المدوّية للمواقفيين)، سرعان ما أصبحنا قبل كل شيءٍ سريعي التأثر بتباعدٍ عميق تجاه كل أشكال الفعل والتأمل: فلا التدخل المباشر، ولا النضالية الإصلاحية (حتى لا نقول «الثورية» فلم يظهر يومًا على الإطلاق شعارٌ ثوري بالمعنى المحدد ـ أي يستهدفُ الاستيلاءَ على السلطة) يجب أن يسودَ بالنسبة لنا. وحتى ونحن نكرِّس أنفسنا بدقةٍ لفعلٍ معين (في المقام الأول من نوع «الحدث؟» كما يمكن القول) كان لدينا وعيٌ حيٌ بأن الرهان لم يكن هناك. لم يكن الأمر متعلقًا بوسائل نضالٍ جديدة. بل توجب تجنُّب الإفراط في السعي إلى الأهداف: فمثلًا، تأسيسُ «جامعةٍ نقدية»، الأمر الذي كان يثيرُ الكثيرَ من الحماس، بدا لنا خطأً. فلا يجب تأسيس شيءٍ، ولا إعادةِ تأسيسه. بل توجب الإبقاءُ على مسافةٍ مع كل الإيماءاتِ من ذلك النوع. بالمقابل، لم يكن الرهانُ هو الابتهاجُ بنوعٍ من الأناركية العدمية ورؤية كل التأكيدات وكل المؤسسات ترتجفُ دون أن نحمِلَ همَّ تخريبها فعليًا، ولا همَّ استبدالها، لا، كان الرهان هو اتخاذ الإجراء لتغييرٍ جعلهُ الحدثُ راهنا: كشفَ عالمٌ كاملٌ من التأكيدات، والمؤسسات، والبنيات، والدلائل، عن كونه في حالةِ تشنُّج. لم يعد في «أزمةٍ» قابلةٍ للشفاء ــ على الطريقة التي أمكن لهوسرل التفكير بها في «أزمة العلوم الأوروبية» ــ بل في تشنجِ احتضارٍ أو تحوّلٍ لا يمكن ولا يجب توقُّع نهايته. التوقع، المشروع، كان هو بالضبط ما يجب أن يتراجعَ لبعض الوقت كي نتعلم طريقةً جديدة لتمحيص التاريخ: لم يعد تاريخا نحن ذواته، بل تاريخٌ يباغتُنا ويجتاحنا.
كان ذلك يعني أيضًا: لم تعد حقيقةً قادمة، موضوعًا لقصدٍ أو لإرادةٍ، بل حقيقةٌ في الحاضر، الحقيقة التي هي أبعد من المشروع (الذي يؤسِّسها، بلا شك، لكن لا يمكنه إشباعها)؛ شيئًا من قبيل توكيد الوجود في العالم على حساب كلِّ مشاريعِ تشييد أو توليد معنى العالم.
في هذا، كان 68 «ميتافيزيقيًا» أو «روحيًا» أكثر من كونه اجتماعيًا، أو سياسيًا، أو ثقافيًا، أو ما شئت. بالتأكيد، كان كل ذلك أيضًا: لكن عمق المسألة، التوهُّج الخاص بتلك اللحظة، كان هذا التحوُّل، تعليقَ توجّهٍ للمعنى لم يكن يُعرِّف ما هو أقل من الحضارة الغربية.
قد تظنين أنني أهذي، أو على الأقل أنني أجنحُ للمبالغة والمغالاة. على الإطلاق: أؤكّد أن شيئًا من هذا النوع بالضبط هو ما منحنا إياه حدثُ ذلك الحين. كلُّ عناصر الأزمة والإصلاح التي اختلطت فيه، كل المحاولات الثورية أو التخريبية لم تجعلهُ يترسَّبُ في بوتقةٍ كان فيها كل شيءٍ، في نهاية المطاف، منصهرًا في لهبٍ آخر تمامًا. دون ذلك، ليس من الممكن فهمُ فورةِ الاحتفال الاستثنائية ووفرة الاكتشافات الجديدة: فيها، أشار 68 إلى شيءٍ آخر بخلاف الأزمة والنقد. هذا الشيءُ الآخر، هو ما لا نتوقفُ عن السعي إلى تسميته منذ ذلك الحين ــ إنه برهان على أن الأمر يتعلَّقُ بشيء بلا اسم i
ك ديلي: السرد الذي قمتَ به للتو له دلائل، وقد عبَّرت عن نفسك في الماضي. وفي نفس الوقت، ها أنت تُعيد التفكير كفيلسوفٍ في قلب الظاهرة كما عشتَها وتواصِلُ الشعورَ بها، بعد أربعين عامًا ــ أود أن أقول في حضور prés-ence، مُفتَرِضةً أن جان ـ لوك نانسي عام 1968 لم يكن قد شحذَ هذه الكلمة بعد. إذن بخصوص «التحوُّل» الذي رسمته، تباعد ذاتٍ تُخطط تاريخها وتقدمها، ودون أن أظن أنك تهذي، أتساءل هل تُفكّرُ في شيءٍ حدث، أو يحدث بالأحرى، يستمر في الحدوث. هل كان هذا التحول يجري منذ ما قبل 68؟
جان ـ لوك نانسي: نعم، أظن أنكِ تفهمينني: ما يشغلُني حدثَ في 68 كعرَضٍ حاد، لكنه لا يكفُّ عن الحدوث ليس كعَرَضٍ مرضيٍ بالتأكيد بل كمحصِّلةٍ، بالأحرى، لكثيرٍ من علامات، وأسئلة، ومخاوف عصرنا. ومن هنا، عجزٌ بالغ الثِّقل للسياسة بعد 68 ــ في نوعٍ من الطيَّة المزدوجة يترافقُ فيها فقدانُ اعتبارِ الممارسةِ السياسية ذاتها مع بحثٍ منشغل عن أشكالٍ جديدة للفعل (ترافُقيّة، تشاركية، محلية، أقلياتية...) وفي نفس الوقت مع عودةٍ لا تقل انشغالًا صوب تدخلات الدولة (في مواجهة الاختلالات المالية، والأزمة البترولية الجديدة) ومناشداتٍ ملحة للقانون الدولي... ــ ومن هنا أيضا كلُّ الأشكال التي تأخذها أبحاث وخبرات الفنانين مع استنزافٍ محسوس لنفس أشكال «الحداثة» المفترَضة، لـ«إبداعها» أو لـ«تجلياتها». كان هذا قد بدأ من قبل: وفي الواقع، فإن جيلي (لنقل، الجيل الذي تخرّج من المدرسة الثانوية بين عامي 56 و 58) هو أول من عانى من نوعٍ من تأثير الخواء : فهناك حيث فكَّر من يكبروننا بقوةٍ في مقاومة الأنظمة الشمولية، في إطلاق مسيرة أوروبا، وفي نزعةٍ تقدمية ذات أفقٍ اشتراكي بدرجةٍ أو بأخرى، بدأنا نحن نُعاني من نقصٍ في الكلام أو في الفكر. وحدثت بعدها مباشرةً ــ حوالي 68 بالضبط ــ الفورةُ الاستثنائية للفكر الفلسفي والفني التي نعرفها والتي تعرَّفنا فيها لحسن الحظ على روحٍ جديدة. لكن هذه الروح حدّدت في نفس الآن، من أوجهٍ عديدة، مكاًنا آخر ، مكانًا آخر بالنسبة للتاريخ، للنزعة الإنسانية، للتأكيدات الديموقراطية والقانونية، للاتساق العام لـ«العقلانية» الغربية (أو إذا شئتِ لما كنا نجمعُه آنذاك تحت كلمة «الميتافيزيقا»، بشيءٍ من التهور، لكن هذا لا يهم هنا) .
أعتقد أنني يمكن أن ألخِّص الأمر على هذا النحو: نعم، إنه العقلُ الموروث عن النهضة، عن الأنوار، عن كانط وهيجل (ومن ثم عن ماركس أيضًا)، ما أصبح لا مناصَ من التعاملِ معه. المطلب الخفيُّ بدرجةٍ أو بأخرى الذي أتحدثُ عنه والذي كان 68 عرَضًا له هو هذا: كيف يمكن التعاملُ مع «الأنوار» (فهذا المصطلح هو الأكثر رمزيةً)؟ مثلًا: لماذا وبأي معنى نسمِّي «الأنوار الجديدة» مثلما فعل ديريدا؟ بعبارةٍ أخرى، كيف نُعيد فتح العقل إلى مدىً أبعد، وأسمى، وأكثر تقدمًا؟ لكن في نفس الوقت لم تتوقف العقلانيةُ التقنيةُ والرأسماليةُ ذات الغاياتِ غير المحدَّدة والتكافؤِ التجاري اللامبالي إزاء المظالم والاستغلالات عن الانتصار في كل مكان، مرتكزةً بصورةٍ بائسة على عقلانيةٍ قانونية تجهد لشحذ «حقوق الإنسان» التي لا تكفُّ عن إرجاء مسألة هذا «الإنسان» ذاته. هذا ما تتعلَّق به المسألة إذن: أن نُعيد صُنعَ عقلٍ لنا ــ حيث يبدو في كل مكانٍ أننا لا نستطيعُ أفضل من أن نصنعَ لنا سببا (للعنف الحربي، والمافيوي، والمالي، والمُلوِّث…) .
ك ديلي: في كتابك حقيقة الديموقراطية ، تكشف أن 68 طرح بجهدٍ جديد سؤال الديموقراطية وتكتب من البداية أنه ما من ميراثٍ لـ 68. وقد تساءلتُ أعلاه، فضلًا عن أننا عنونَّا هذا الملف من بعنوان «ميراث مايو 68». سألت نفسي إن كنتَ ستتحدث عن ميراث الثورة الفرنسية مثلًا، لنقل عن الأنوار، الأمر الذي فعلتَه هنا للتو. غالبًا ما أصر جاك ديريدا عن حق على أهمية الميراث، على احترامه، على خيانته بالوفاء له، «نحن وارثون بكل ما في الكلمة من معنى». لدي انطباعٌ بأن هذا التفكير، لنقُل إنه لذاتٍ بوصفها سيدةً ومالكةً لميراثها، ليس تفكير 68، كأن مفكِّر التفكيك... لكن ربما كنت أُخاطر؟
جان ـ لوك نانسي: ليست لديّ بالتأكيد نفس علاقة جاك ديريدا بفكرة «الميراث». وإذا أردنا القيامَ بقليل من السيرة الذاتية، لقلتُ إنه كانت لديه ميراثاتٌ عديدة تلقَّاها بوفاء الوريث الذي يعرف أنه يتلقى وديعةً ويجب أن يسهرَ عليها ويجعلها تثمر. كان لديه ميراثٌ جزائري، وميراث يهودي، وميراث فرنسي: كلٌ منها بارزٌ كـ«ميراثٍ» بالضبط بسبب اختلافه وتجاوره مع الآخرين. أما أنا، فوريثٌ لميراثٍ واحد بالغ الضخامة ومُتَّفقٍ عليه ــ فرنسي، كاثوليكي، للـ«طبقة المتوسطة العليا» (أقل شعبيةً إذن من جاك ديريدا) ــ بحيث يصبح غير مُتميِّزٍ أو غيرَ مرئيٍ بوصفه ميراثًا. لا أشعر أنني حاملُ وديعةٍ للنقل: بل كنتُ أميل بالأحرى إلى نبذ ما كان متفقًا عليه من جانب «طبقتي»، فيما يخص السلوكاتِ المبرمجة على الأقل. لكن لا هامشيةَ، ولا حيود: أعتقدُ أنه بالنسبة لي مثلما بالنسبة لجاك ديريدا، فإن العمل الفكري هو في الأغلب نبذٌ، قطيعةٌ مع صورةٍ معينة للـ«ميراث» .
لكن لنَنسَ السيرةَ الذاتية، ولنعُد إلى 68. بنفي وجودِ «ميراثٍ» لـ68 أردتُ أن أنفي حدوث «وفاة»، بدونها ليس ثمة ميراث. لم تحدث وفاةٌ لأن شيئًا لم يتوقف (بالتأكيد، باستثناء «الأحداث كما كان يُقال حينها). لقد بدأ كلُّ شيءٍ في 68 فحسب: كلُّ شيء، أي نُذُر تغيُّرٍ في الحضارة. لا أتردّدُ في قول الأمر على هذا النحو، لأنه أكثر من تغيرٍ في «المجتمع» أو في «الثقافة»، أو في «الفكر». حدَسنا حينئذ (ليس على طريقة التوقُّع، طريقة التصوّر المستقبلي، لا، بل على الطريقةِ غير المحددَّةٍ لإدراك الحاضرِ بوصفه في قطيعةٍ مع مجرى الأشياء) أن العالم يتغير. العالم: شبكةُ التداولات الممكنة للمعنى. مجددًا، مجرى الأشياء: كان 68 يعني أن مجرى الأشياء لم يعد «يجري»، لم يعد يتبع مجراه. ثمة شيءٌ لم يعد يتبعُ مجراه: مجرى التاريخ، مجرى التقدُّم، مجرى الإنسانية المنعتقة، والعقلانية، وسيدةِ مصيرها. حدَسَ 68 بصورةٍ مبهمة أن «السردية الكبرى» (كما سيقول ليوتار فيما بعد) للإنسانية التقدمية، والديموقراطية، العقلانية والمعقولة لم يعُد أمامها مجرى متصلٌ ومُمهَّد. على النقيض كان مسدودًا، مختنقًا، منحرفًا عن مساره، أو ارتجاعيًا. هكذا كان لدى 68 ذكاءُ أو حدسُ إدراك أن الزلزلات العنيفة لحربين ولأنظمةٍ «شمولية» لم تكن حوادثَ مؤسفةً أو أزماتٍ نخرجُ منها لنُعاود مجرى الإنسانية، تلك الإنسانية إذا شئتٍ.
لهذا السبب لا أرى هنا مشكلةَ ميراث. وفيما عدا ذلك، فإن ما تقولينه عن ديريدا يبدو لي، حتى كفرضيةٍ سرعان ما تم التخلّي عنها كما تفعلين، محفوفًا بالمخاطر. ليس في ذهني نصٌ لكنني متأكدٌ أن الاندراج في التقاليد بالنسبة له ــ النقل، التوصيل، العبور ــ لم يكن يتضمن أي «سيادةٍ» من جانب «ذاتٍ» لا أدريها. لا أرى هناك سوى دربٍ زائف، وإلاّ يجبُ إطلاعي على النصوص. أنت نفسك تقولين من جهةٍ أخرى أنه يتحدث عن «خيانة عن طريق الوفاء» للميراث: وهذا يعني أن الوفاء للعنصر الأعمق، وأحيانًا أيضًا الأشد انطمارًا، من تقاليدٍ ما يمكنُ أن يتضمَّن خيانة الأشكال الأشدِ وضوحًا ورسوخًا. فمثلًا: ماذا يعني الوفاء للشيوعية؟... لا أجيبُ، فأنا أعتقد أنك تفهمينني جيدًا جدًا!
ك ديلي: تكتبُ في نفس الكتاب أن التكافؤ التجاري للرأسمالية قد أنتج نظامًا من التكافؤ المُعمَّم في المجتمعات الديموقراطية على طريقة «كل شيءٍ يصلح». يجب الحفاظُ على نصيب «ما ليس له قيمةٌ لأنه خارجَ كل قيمةٍ قابلةٍ للقياس»، الإبداع، الحب، الفكر، كل ما يحمل رغبةً؛ وضد شعار «كلُّ شيءٍ سياسةٌ» لـ 68، تقول أنتَ إن على السياسة أن تُديرَ ذلك الفضاء دون أن تستثمرَهُ. والخشيةُ التي يمكن أن تُصيبنا اليوم، هي أن كلَّ شيءٍ يعتمدُ في التحليل الأخير على الرأسمالية المالية، التي أصبحت لعبةَ عددٍ ضئيلٍ من الأشخاص في العالم وخارجةً تقريبا عن السيطرة (فأزمة الرهون العقارية قد أفلتت من كل توقّع). بين المضاءِ الهائل للفكر الذي أتي بعد 68 ــ عام مؤتمر جاك ديريدا الشاب في نيويورك، «نهايات الإنسان» ــ وبين المجرى الكئيب باطراد للأحداث، يبدو الانفصالُ مُلفِتًا. دون البحث عن حركةٍ تاريخية، يود المرء أن يجد في ذلك معنى، أن يستطيع المواجهة بالفكر...
جان ـ لوك نانسي: لم أُرِد بالتحديد أن يُفهَم أن الرأسمالية «قد أنتجت... نظامًا... في المجتمعات الديموقراطية»: لا بالتحديد! وددتُ أن يُفهم أن الرأسمالية والديموقراطية لهما من ناحيةٍ معينة دورٌ وثيق بقدر ما تحيلان معًا إلى إمكان مقولة «كل شيءٍ يصلح»، التي تجدُ مصدرها في تكافؤٍ مُعمَّم بالنسبة له يضمُ تبادلُ السلع أيضا تبادلَ القوى العاملة و/أو وسائل الإنتاج بين أفرادٍ متكافئين من ناحية المبدأ ومُنظَّمين في الممارسة على أساس، وبواسطة استغلالٍ وسيطرةٍ للبعض على الآخرين. والاستغلال الأشد التواءً والذي يمرّ من خلال الاستقلال الذاتي النسبي للعمليات المالية يقدم طبعةً أشدَّ دهاء، وربما أيضا أشد هشاشةً لكنها ليست أقلَ رعبًا.
أعتقدُ أن هذا المجموع ــ تكافؤ الأفراد، والحيوات، والأشياء القابلة للتحويل إلى نقود دون تمييز وبالأخص (لأن كل شيءِ كان بمعنى من المعاني قابلًا للتحويل إلى نقودٍ منذ أن وُجدت النقود) المحوَّلة إلى نقودٍ بالفعل (الأعمال الفنية المشتراة بالفعل، والمُسعَّرة، والمستثمرة، المناظر الطبيعية، والماء، والهواء، وحتى الشمس…)، على خلفية المساواة بين كل لحظةٍ، وكل شكلٍ، وكل تألُّقٍ للمعنى يمكن أن يُستمدّ من التكافؤ ــ أعتقد، إذن، أنه سيكون قد أصبح «الاختيار» (دون تدبُّرٍ ولا قرار) لحضارةٍ بأكملها. وأننا في الحاضر ظهرُنا للجدار: فهذه الحضارة تدمِّر نفسها ضمن استغلالها ذاتِه للبشر، وللطبيعة، ولما سأسمِّيه، نظرًا لعدم وجود لفظٍ أفضل، باسم “اللانهائي” حتى لا أقول “الإلهي».
ما من صدفةٍ في أن تظهر المسيحيةُ وتنتشر (تسبقها وتتلوها في ذلك من جوانب متعددةٍ الصورتان الأخريان للتوحيدية) كوجهٍ مجيد بصورةٍ مقدسة للتكافؤ: الكلُّ متساوون، الكلُّ إخوة، لا إغريقَ، ولا يهودَ، لا بشرَ أحرار ولا عبيد، لا رجالَ ولا نساء ــ بل بمعنيً توجَّبَ أن يكون: كلُّ واحدٍ فريد، كلُّ واحدٍ في استثناءٍ متفردٍ مطلق. إذا كانت المسيحية تترافقُ بشكلٍ جيد مع الرأسمالية، لدرجة أن تفقدَ فيها روحها ــ بقدر ملاءمة هذا القول ــ فذلك بسبب قابلية التبادل البالغة التآمرية لتكافؤين: تكافؤ رأس المال وتكافؤ الخلاص.
أنا لا أسعى إلى فك عقدة هذا التشابك: فما انبثق عن اختيارٍ جوهري، أو إذا فضَّلت، عن نزوعٍ سائد للبشرية في الغرب ــ وهذا، منذ «ما قبل ـ الرأسمالية» ــ لا يمكن العودةُ فيه أو حَرْفُ اتجاهه إلاّ بتأثير نزوعٍ آخر واختيارٍ آخر. لا نستطيع بالتأكيد أن «نختار» كذواتٍ ذات اختيارٍ حر (تبدٍ آخر مُشيَّد لمصاحبة التكافؤ) لكننا نستطيعُ محاولةَ فهمِ كيف يحكمنا «اختيارٌ» لاطوعي، ومع ذلك قد يجدُ نفسه بدوره مطرودًا، مُزَاحًا، معكوسًا بواسطة اختيارٍ آخر. لقد اعتقدنا منذ عهدٍ قريب أننا نستطيع فتحَ مسارٍ جديد للتاريخ ــ عمدناه «الاشتراكية»: وكان الخطأ أننا اعتقدنا أن أمامنا خططًا ممكنة وروافع للتحويل. لكننا اليوم يتوجب علينا معرفة أننا دون خطةٍ ودون تحويل لكن مدعوين رغم كل شيء إلى النزوع على نحوٍ آخر... مؤكدٌ، أنك على حق، فبين عامي 68 و80 (حين استعدنا هذا العنوان لمنتدى سيريزي لاكو ـ لابارت وأنا) كنا ما زلنا نعتقد، سواء بطريقةٍ معقدة، قلقةٍ على أي حال ومنفصلةٍ بالفعل عن «معنى التاريخ» أن نهايات الإنسان يمكنها، إن لم تكن شعارًا، أن تكون، على الأقل شيئًا من قبيل «التوجُّه»orientation . بعدها انمحى كل مخططٍ لأي نوعٍ من «الشرق»، في آن واحد مع مخطط «الغرب». واستعادهما اقتسامٌ جديد للاستغلال، إعادة توزيعٍ للعالم فيه لم تعد «النهايات» هي المشوَّشة والمتبخرة، بل «الإنسان». كان سؤال «النزعة الإنسانية» حاضرًا بالفعل عام 68 ــ وكان علاوةً على ذلك كثيرًا ما يلقى استقبالًا سيئًا كسؤال. لِم نشأ معرفة أن «النزعة الإنسانية» تفصلُ الإنسانَ عن اللامتناهي. واليوم نعرف ذلك. وليست هذه معرفة ضد «الإنسان»: بل معرفةً تفتح على اتساعه التساؤلَ لا عما «يعني»، أو «يكون»، أو «يمثِّل» «الإنسان»، بل عما ينادي به. صوب ماذا ينادي «الإنسان»؟ أو صوب من؟ صوب «إنسانٍ» ما زال، ربما، لكن كيف، في أية شروط، ووفق أي انفتاحٍ لا نهائي.
عن موقع كتب مملة
عن